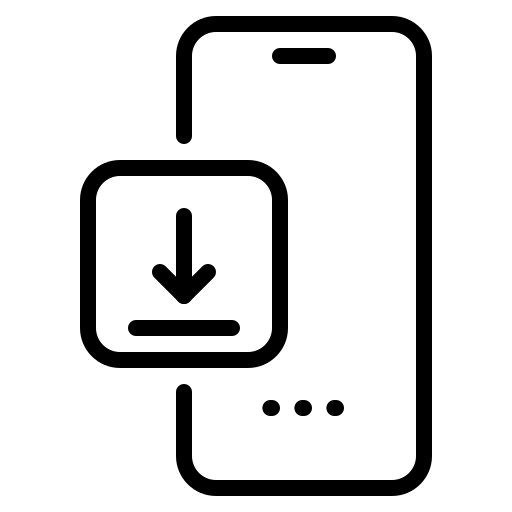سيد الأحجار السبعة
عابر الزمن الثالث
- المشاركات
- 933
- مستوى التفاعل
- 1,699
فكرة الإلحاد بغض النظر عن تنميطها ولغتها، تعتمد أساساً معرفياً واحداً :
أن ظاهر الكون بما هو موضوع محلي مُباشر يحضُر للحواس الجسدية [ أي دون معرفة الجوهر - ودون معرفة الحقيقة المُطلقة ] هو الشيء الوحيد القابل للمعرفة بالنسبة للناس، لأنه هو كل شيء وليس وراءه أي وجود من أي نوع آخر.
الظاهر المحسوس هو ما يُقصَد منه مجموعة العناصر المادية التي تشكل معاً نسيج الكون المُفارق للذات ذاتياً، فهو ليس شيئاً له ذاتية أو كينونة داخلية مستقلّة ، أي أن الظاهر هو "الشيء المُدرَك حسياً" والباطن هو "الشيء في ذاته"، والإلحاد يقول إنه لا مجال للتعرف على الشيء في ذاته، أي خارج الرصد الحسي المادي ، لأن ذات الشيء إذا كان حقيقة فهو مختلف عن ظاهره، وليس شكلياً أو ببعض الصفات، إنه مختلف جوهرياً.
ذاتك تُدرِك الكون المحسوس كمُعطى خارجي مفارق لها، تدرِكه كشيء غيرها، شيء هُناك ، وهذا الفاصل بينهما هو ما يجعل الكون الظاهري محل التشكيك والنقد المُستمر ويجعله خالياً من الحقيقة بالمعنى الدقيق، لأن الذات الواعية لا تتصل بوعيها وشعورها بذات الموضوع الذي ترصده، ولكن تعتمد على صورته ومادته لعرفته، وكلاهما هو تفاعله الكوني مع الرصد، الذي يتغير مع الزمن ويتحدد بوعاء المكان. إن الظاهر الذي لا يُدرَك له باطن، يغيب ذاتياً عن الذات التي تُدرِكه، ويقترب إلى أن يكون نوعاً من الوهم الجبري على الحواس، أو النمطي والمنسّق بنظام.
الإلحاد هو أن تُنكر الذاتية في الأشياء وتكتفي بأثرها المرصود ظاهرياً والذي يشكل ما نسميه ب"العالم الفيزيائي"، هذا هو الأساس في إنكار الغيبيات، الإلحاد لا يحاول أن يقول لك إنك لا ترصُد ذات الشيء وغيبه، بل يريد القول لك "ليس هناك ذاتيات أصلاً" وليس هُناك إلا ما ترصُده عينك وأذنك الفيزيائية.
بمعنىً من المعاني يقضي الإلحاد أن تتعامل مع العالم الفيزيائي دون تحقيق إدراكي في مسألة ذاتية الشيء مقابل موضوعيته، لأن موقف فصلك لذاتية الموضوع الباطنية عن ظاهره المرصود موضوعياً يعني أيضاً اعترافك بوجود ذاتية لا ترصدها ولا يمكن أن تكون موضوعاً للرصد الموضوعي أيضاً، ذاتية الموضوع يمكن إدراكها أو التواصل معها دون حواجز الزمكان، ولذلك هي ليست بالشيء الذي يمكن أن يُطلَق عليه ظاهر أو نسبي أو مادي أو محدود، والإلحاد هو أن تتخذ موقف عدم الاعتراف بمثل ذلك الوجود.
يجب أن تعلَم أن الظاهر أو الوجود الواقع أرصادياً Factual Existence يكون محدداً بحسب طبيعة الأدوات التي رصدتَه بها، فإذا كانت الأدوات مادية سيكون الظاهر مادة، إذا كانت الأدوات عقلية سيكون الظاهر تجريداً، إذا كانت صلتك بالواقع روحية أو حدسية فسيكون نوعاً من الوحي أو التجلي أو الإلهام.
لذلك الظاهر المادي هو جزء من الظاهر المُطلَق، وهو حالة طبيعية في عالم مُحدد مسبقاً ليكون هكذا ، ورصدُك للظاهر المادي لا يعني أن الشيء الوحيد القابل للظهور هو شيء مادي، ولكن أن حواسك لا يمكن أن يظهر لها شيء يتجاوز قدرتها على الأرصاد، وهو أمر أصبح معروفاً إلى حد ما، فحتى في حالة المعرفة المادية هناك حدود على الحواس فالعين البشرية أقل جودة في الرصد المادي من عيون الجوارح بكثير، وآذان البوم ليست كآذان البشر، والخفافيش تملك فعلياً حساسات راديوية تنقل لها ضرباً من الأحاسيس التي لا نعرف نكهتها بعد، فلما لا تكون الحواس المادية نفسها محدودة نوعياً لا كمياً فقط.
هذا يجعلنا نُفرق بين الوجود الواقع والوجود المحلي Local Existence لأن الأخير يعني حصراً الظاهر للحواس الجسدية التي تتصل بالأشياء محلياً عبر مسافات وفترات.
الآن أنت ترصد غُرفتك، بيتك و المدينة والأفق السماوي من محلّك الخاص فيزيائياً أي من الإحداثيات كذا وكذا على خطوط طول وعرض الأرض، والإحداثيات كذا وكذا في ميقات رصدك، هذه معرفة بالمعطيات Data ، وهي معرفة حسية صريحة ومباشرة بموضوعات حسية ولذلك تسمى ب"الانطباعات" Impressions وهي التي تُدركها مباشرة ودون تفكير، حسك بحرارة النار لا يحتاج إلى تفكير.
هذه الانطباعات لا تخبرك بأحكام منطقية محددة عن العالم من سنخ الإثبات والنفي، يبدأ البناء المنطقي للعالم في اللحظة التي تترك فيها الإحساس المباشر بالانطباع وتحيله إلى "صورة Concept" ، ومع مرور الوقت تتكاثر الصور وتتكاثر معها العلاقات المنطقية لتصل في النهاية حداً يشكل رؤيتك عن العالَم بأسره.
الإلحاد :
هو "الصورة الذهنية عن العالَم المحسوس ظاهرياً، التي تصوّره على أنه عالمُ مغلق بما هو شيء ظاهر"، خالي من الذاتية والمعنى والجوهر والمُطلَق. وهذا الاشتراط المنطقي على العالم ليس من قبيل الأحكام القابلة للبحث، لأنه يرفُض أساساً أي بوابة للمعرفة لا تنتمي للحواس الجسدية ولا تخبر بالموضوعات المحلية.
بمعنىً أدق ... الإلحاد ينغلِق على نفسه ... ويتخذ العقيدة والمصادرة كمبدأ لا كنتيجة، شأنه بذلك شأن المذهب المادي في المعرفة والوجود والذي يشكل جناحي الإلحاد في القضايا العلمية والفلسفية، ولذلك يصف الفلاسفة الإلحاد بأنه "النزعة الطبيعية الساذجة" ويصفه هوسِرل بأنه "السذاجة الأبدية" ... هذه ليست محاولة للشتم ولكنها صفة دقيقة تقنياً.
هكذا نعلمُ أن الإلحاد بالمعنى الصحيح للكلمة، ليس هو إنكار الخالق، لأن المُلحد قد يقبل بوجود خالق للكون إذا كان هذا الخالق بشرياً صمم محاكاة مثلاً، أو كان مكوّناً من المادة، فالمسألة عند المُلحد هو أن الخالِق يجب أن يكون موضوعياً [هُناك] وبالتالي ليس له ذاتية، وهذا يجعله أشبه بالعقل الإلكتروني، لا يهم في الإلحاد هل هناك خالِق أم لا، ولا هل هناك كائن فائق أم لا، ولكن ما يهم هل طبيعة وجود هذا الكائن الفائق أو الخالق هي طبيعة ظاهرية مادية محلية، أو له "وجود حق".
ماذا يعني ذلك ... أن العالم الذي نراه لا وجود له !
لا ... ولكن أن العالم المادي الذي تراه عادة ، يكون شكلاً من أشكال التعبيرات عن الحقيقة المُطلقة، ولكنه ذلك التعبير الذي يحجبها ويبقي على الشكل نفسه، لأن هذا العالم لا ينشأ إلا إذا صرف الإدراك بصيرته عن كل شيء سوى الالتفات نحو التعبير الظاهري المحلي المفارق للذاتية.
ذلك يعود إلى القيد المحلي على الإحساس الجسدي بظاهر العالم الحقيقي.
في الفلسفة يسمى الإلحاد بالنزعة الطبيعية الساذجة، لأنه يُغرِق في الالتصاق بالأثر ويترُك العلل الجوهرية التي أدت به إلى الوجود
وكل ما يُبنى عليه من معرفة يأتي من إعمال الذهن فيه، والروح تكون نوعاً من أنواع العمل الذهني الممارس على المعطيات الحسية، فليس هناك روحٌ بالمعنى الجوهري ، فيكون اللاهوت حينها جزءً من هذا الظاهر الذي لا باطن له، أي هو جزء من النظام، أي من حالة الظهور نفسها، وتصوير الإنسان كمادة، وتصوير قيمته بأسرها في مادته ...
إذن ، فكرة الإلحاد ليست في الحكم على تصور وجود الخالق أو عدم وجوده، أو عن تصورات الكون، ولكن ... هي في نوع الرغبة وطريقة الإدراك والحياة المبنية عليها، ولذلك فإن حركات الروحانية الحديثة التي تروج اليوم في عالم العرب ، تتخذ نفس الأبعاد الإلحادية للقرن الثامن عشر.
أن ظاهر الكون بما هو موضوع محلي مُباشر يحضُر للحواس الجسدية [ أي دون معرفة الجوهر - ودون معرفة الحقيقة المُطلقة ] هو الشيء الوحيد القابل للمعرفة بالنسبة للناس، لأنه هو كل شيء وليس وراءه أي وجود من أي نوع آخر.
الظاهر المحسوس هو ما يُقصَد منه مجموعة العناصر المادية التي تشكل معاً نسيج الكون المُفارق للذات ذاتياً، فهو ليس شيئاً له ذاتية أو كينونة داخلية مستقلّة ، أي أن الظاهر هو "الشيء المُدرَك حسياً" والباطن هو "الشيء في ذاته"، والإلحاد يقول إنه لا مجال للتعرف على الشيء في ذاته، أي خارج الرصد الحسي المادي ، لأن ذات الشيء إذا كان حقيقة فهو مختلف عن ظاهره، وليس شكلياً أو ببعض الصفات، إنه مختلف جوهرياً.
ذاتك تُدرِك الكون المحسوس كمُعطى خارجي مفارق لها، تدرِكه كشيء غيرها، شيء هُناك ، وهذا الفاصل بينهما هو ما يجعل الكون الظاهري محل التشكيك والنقد المُستمر ويجعله خالياً من الحقيقة بالمعنى الدقيق، لأن الذات الواعية لا تتصل بوعيها وشعورها بذات الموضوع الذي ترصده، ولكن تعتمد على صورته ومادته لعرفته، وكلاهما هو تفاعله الكوني مع الرصد، الذي يتغير مع الزمن ويتحدد بوعاء المكان. إن الظاهر الذي لا يُدرَك له باطن، يغيب ذاتياً عن الذات التي تُدرِكه، ويقترب إلى أن يكون نوعاً من الوهم الجبري على الحواس، أو النمطي والمنسّق بنظام.
الإلحاد هو أن تُنكر الذاتية في الأشياء وتكتفي بأثرها المرصود ظاهرياً والذي يشكل ما نسميه ب"العالم الفيزيائي"، هذا هو الأساس في إنكار الغيبيات، الإلحاد لا يحاول أن يقول لك إنك لا ترصُد ذات الشيء وغيبه، بل يريد القول لك "ليس هناك ذاتيات أصلاً" وليس هُناك إلا ما ترصُده عينك وأذنك الفيزيائية.
بمعنىً من المعاني يقضي الإلحاد أن تتعامل مع العالم الفيزيائي دون تحقيق إدراكي في مسألة ذاتية الشيء مقابل موضوعيته، لأن موقف فصلك لذاتية الموضوع الباطنية عن ظاهره المرصود موضوعياً يعني أيضاً اعترافك بوجود ذاتية لا ترصدها ولا يمكن أن تكون موضوعاً للرصد الموضوعي أيضاً، ذاتية الموضوع يمكن إدراكها أو التواصل معها دون حواجز الزمكان، ولذلك هي ليست بالشيء الذي يمكن أن يُطلَق عليه ظاهر أو نسبي أو مادي أو محدود، والإلحاد هو أن تتخذ موقف عدم الاعتراف بمثل ذلك الوجود.
يجب أن تعلَم أن الظاهر أو الوجود الواقع أرصادياً Factual Existence يكون محدداً بحسب طبيعة الأدوات التي رصدتَه بها، فإذا كانت الأدوات مادية سيكون الظاهر مادة، إذا كانت الأدوات عقلية سيكون الظاهر تجريداً، إذا كانت صلتك بالواقع روحية أو حدسية فسيكون نوعاً من الوحي أو التجلي أو الإلهام.
لذلك الظاهر المادي هو جزء من الظاهر المُطلَق، وهو حالة طبيعية في عالم مُحدد مسبقاً ليكون هكذا ، ورصدُك للظاهر المادي لا يعني أن الشيء الوحيد القابل للظهور هو شيء مادي، ولكن أن حواسك لا يمكن أن يظهر لها شيء يتجاوز قدرتها على الأرصاد، وهو أمر أصبح معروفاً إلى حد ما، فحتى في حالة المعرفة المادية هناك حدود على الحواس فالعين البشرية أقل جودة في الرصد المادي من عيون الجوارح بكثير، وآذان البوم ليست كآذان البشر، والخفافيش تملك فعلياً حساسات راديوية تنقل لها ضرباً من الأحاسيس التي لا نعرف نكهتها بعد، فلما لا تكون الحواس المادية نفسها محدودة نوعياً لا كمياً فقط.
هذا يجعلنا نُفرق بين الوجود الواقع والوجود المحلي Local Existence لأن الأخير يعني حصراً الظاهر للحواس الجسدية التي تتصل بالأشياء محلياً عبر مسافات وفترات.
الآن أنت ترصد غُرفتك، بيتك و المدينة والأفق السماوي من محلّك الخاص فيزيائياً أي من الإحداثيات كذا وكذا على خطوط طول وعرض الأرض، والإحداثيات كذا وكذا في ميقات رصدك، هذه معرفة بالمعطيات Data ، وهي معرفة حسية صريحة ومباشرة بموضوعات حسية ولذلك تسمى ب"الانطباعات" Impressions وهي التي تُدركها مباشرة ودون تفكير، حسك بحرارة النار لا يحتاج إلى تفكير.
هذه الانطباعات لا تخبرك بأحكام منطقية محددة عن العالم من سنخ الإثبات والنفي، يبدأ البناء المنطقي للعالم في اللحظة التي تترك فيها الإحساس المباشر بالانطباع وتحيله إلى "صورة Concept" ، ومع مرور الوقت تتكاثر الصور وتتكاثر معها العلاقات المنطقية لتصل في النهاية حداً يشكل رؤيتك عن العالَم بأسره.
الإلحاد :
هو "الصورة الذهنية عن العالَم المحسوس ظاهرياً، التي تصوّره على أنه عالمُ مغلق بما هو شيء ظاهر"، خالي من الذاتية والمعنى والجوهر والمُطلَق. وهذا الاشتراط المنطقي على العالم ليس من قبيل الأحكام القابلة للبحث، لأنه يرفُض أساساً أي بوابة للمعرفة لا تنتمي للحواس الجسدية ولا تخبر بالموضوعات المحلية.
بمعنىً أدق ... الإلحاد ينغلِق على نفسه ... ويتخذ العقيدة والمصادرة كمبدأ لا كنتيجة، شأنه بذلك شأن المذهب المادي في المعرفة والوجود والذي يشكل جناحي الإلحاد في القضايا العلمية والفلسفية، ولذلك يصف الفلاسفة الإلحاد بأنه "النزعة الطبيعية الساذجة" ويصفه هوسِرل بأنه "السذاجة الأبدية" ... هذه ليست محاولة للشتم ولكنها صفة دقيقة تقنياً.
هكذا نعلمُ أن الإلحاد بالمعنى الصحيح للكلمة، ليس هو إنكار الخالق، لأن المُلحد قد يقبل بوجود خالق للكون إذا كان هذا الخالق بشرياً صمم محاكاة مثلاً، أو كان مكوّناً من المادة، فالمسألة عند المُلحد هو أن الخالِق يجب أن يكون موضوعياً [هُناك] وبالتالي ليس له ذاتية، وهذا يجعله أشبه بالعقل الإلكتروني، لا يهم في الإلحاد هل هناك خالِق أم لا، ولا هل هناك كائن فائق أم لا، ولكن ما يهم هل طبيعة وجود هذا الكائن الفائق أو الخالق هي طبيعة ظاهرية مادية محلية، أو له "وجود حق".
ماذا يعني ذلك ... أن العالم الذي نراه لا وجود له !
لا ... ولكن أن العالم المادي الذي تراه عادة ، يكون شكلاً من أشكال التعبيرات عن الحقيقة المُطلقة، ولكنه ذلك التعبير الذي يحجبها ويبقي على الشكل نفسه، لأن هذا العالم لا ينشأ إلا إذا صرف الإدراك بصيرته عن كل شيء سوى الالتفات نحو التعبير الظاهري المحلي المفارق للذاتية.
ذلك يعود إلى القيد المحلي على الإحساس الجسدي بظاهر العالم الحقيقي.
في الفلسفة يسمى الإلحاد بالنزعة الطبيعية الساذجة، لأنه يُغرِق في الالتصاق بالأثر ويترُك العلل الجوهرية التي أدت به إلى الوجود
وكل ما يُبنى عليه من معرفة يأتي من إعمال الذهن فيه، والروح تكون نوعاً من أنواع العمل الذهني الممارس على المعطيات الحسية، فليس هناك روحٌ بالمعنى الجوهري ، فيكون اللاهوت حينها جزءً من هذا الظاهر الذي لا باطن له، أي هو جزء من النظام، أي من حالة الظهور نفسها، وتصوير الإنسان كمادة، وتصوير قيمته بأسرها في مادته ...
إذن ، فكرة الإلحاد ليست في الحكم على تصور وجود الخالق أو عدم وجوده، أو عن تصورات الكون، ولكن ... هي في نوع الرغبة وطريقة الإدراك والحياة المبنية عليها، ولذلك فإن حركات الروحانية الحديثة التي تروج اليوم في عالم العرب ، تتخذ نفس الأبعاد الإلحادية للقرن الثامن عشر.
التعديل الأخير: